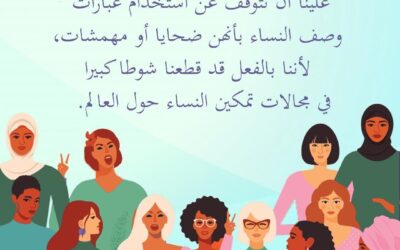من منّا لا يحب فاكهة العنب؟ بدءًا من بهاء خلقته، وتمايز ألوانه، وتفرده بين الفاكهة بقدرته على إثارة البهجة لمجرد تخيّل لحظة قطفه من المزرعة، وتحميله على السيارات، إلى أن يستقر في وعاء داخل الثلاجة، فيصبح أفضل مرطّب لأيام الصيف. وحين يُذكر العنب، يحضر معه الفلكلور المصري، بأهازيجه التي تحتفي بجني المحاصيل، وتنسج بين العمل والفرح نسيجًا شعبيًّا خاصًا، مثل الأغنية الشهيرة:
“على بياعين العنب، العنب عنبي، وانت يا فُكهي يا بتاع العنب…”
ولعلّ أحد أبرز تمثيلات هذا المشهد المتكرّر في المخيلة المصرية الشعبية يظهر في فيلم أفواه وأرانب (1977)، حين نُشاهد الفتيات يعملن في مزرعة العنب، وهنّ يُحمّلن السلال على السيارات بينما تتردد هذه الأغنية في الخلفية؛ مشهدٌ يُزاوج بين الجهد والبهجة، وبين بساطة الحياة وقسوتها، فلا ندري: هل السينما تنقل الواقع أم تُعيد تشكيله؟ وهل المزارع تُغنّي حقًّا أثناء العمل، أم أن الأغنية جزء من ذاكرة سينمائية رسّخت صورة ما عن العمل والأنوثة والريف في الوجدان الجمعي؟
بهذا التداخل بين العنب كمفردة فنية وفلكلورية، وبين واقع فتيات يعملن في قطفه، تتجلى العلاقة بين اللغة والثقافة، وبين الصورة والواقع، كأبعاد متشابكة تُشكّل وعينا ورؤيتنا للهامش والهوية والعمل والغياب.
هكذا صدح الموال الشعبي المصري، حاملًا في طيّاته نغمة من العتاب والحنين، ومُحمّلًا بالعنب كرمز متعدّد الدلالات: الجمال، الخصوبة، الرزق، والحب المفقود؛ لا يقتصر هذا التعبير الفولكلوري على وصف مشهد عاطفي عابر، بل يُعبّر عن بنية شعورية راسخة في الثقافة الريفية المصرية، حيث يُصبح العنب أكثر من ثمرة موسمية، ويتحوّل إلى استعارة للأنثى، للعمل، وللعلاقات الاجتماعية التي تمر عبر الحقول والأسواق والطرقات.
في حادثة فتيات المنوفية — اللواتي خرجن في الصباح الباكر لقطف العنب، وسقطن ضحايا حادث سير مأساوي — تعود هذه المفردات الشعبية، دون أن تُقال، حاضرة في الذاكرة الثقافية الجماعية، فإن وصفهن في الإعلام والشارع بـ”فتيات العنب” لم يكن محايدًا لغويًّا؛ بل استعاد دون وعي صورة قديمة، فيها من الرثاء بقدر ما فيها من الاختزال، فبين العنب كرمز فولكلوري، والعنب كموسم عمل شاق لفتيات صغيرات يحملن أعباء أسرهن، تتقاطع اللغة مع الطبقة والنوع الاجتماعي، ويُعاد إنتاج الهامش بلغةٍ شاعرية تُخفي القسوة الكامنة خلف النص.
تشهد اللغة المستخدمة في توصيف الحوادث المجتمعية، لا سيما تلك المتعلقة بالفئات الهشة والمهمَّشة، دورًا محوريًّا في إنتاج المعنى وتشكيل التصورات الجمعية حول الضحايا وسياقاتهم الاجتماعية، وحادثة طريق «الإقليمي» بمحافظة المنوفية، والتي راح ضحيتها ثماني عشرة فتاة تتراوح أعمارهن بين 14 و19 عامًا أثناء ذهابهن للعمل في قطف العنب، تُعد نموذجًا دالًا على كيفية تداخل اللغة، والهوية، والطبقة، والنوع الاجتماعي في تشكيل الوعي الجماعي بالمأساة، وفي رسم الصورة الذهنية عن الضحية.
فكما عبرت الجملة المختزلة “فتيات العنب” عن حقيقة سائدة في هذا المجتمع الريفي حيث قررن الفتيات الصغيرات تفعيل دورهن داخل الأسرة، كل منهن بحسب احتياجاتها، جاءت التعليقات العامة مشحونة بالتعاطف والأسى، مع تركيز على فداحة الخسارة و”رحيل الأحلام قبل أن تبدأ الحياة”، غير أن هذا الخطاب، رغم صدقه العاطفي، يُعيد إنتاج تمثيلات نمطية عن الفتاة الريفية العاملة بوصفها كائنًا هشًّا، جميلًا، لكنه محكوم مسبقًا بالغياب أو الانكسار، ما يُكرّس صورتها كـ”ضحية صامتة” بدلًا من فاعلة اجتماعية ذات مشروع حياة.
لو نُقلت هذه الحادثة إلى لغة أخرى، كما في حال القارئ غير الناطق بالعربية، ستتقلص الحادثة إلى مفردات مُترجَمة مثل “Grape Girls” أو “Dreams Lost Too Soon” هذه التراكيب، وإن بدت رقيقة ظاهريًّا، فإنها تفتقر إلى السياق الثقافي والاجتماعي الضروري لفهم بنية الحادثة، ولذلك نقول دائمًا إن اللغة مرآة للثقافة، لا يمكن فهمها بعيدًا عن سياقها المجتمعي، وهذه هي أولى مهام المترجم المتخصص المحترف في نقل النص، فالترجمة ليست نقلا عابرا للعبارات والجمل، وإنما صورة عامة لابد أن تتوفر في ذهن المترجم حتى لا تصير مجرد بناء مرصوص بلا روح أو معنى. إن الترجمة، في هذه الحالة، لا تنقل النص فقط، بل تُعيد تشكيل تمثيل ثقافي عن الفتيات وعن المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى تكريس صورة نمطية عن فئة معينة أو مجموعة من البشر تختلف تماما عن حقيقتها التي عليها.
وفقًا لنظرية بورديو في رأس المال الرمزي، فاللغة تُمارس كسلطة اجتماعية، وتُستخدم أحيانًا لتبرير التراتب لا لتفكيكه، وفي حادثة “فتيات العنب”، عملت اللغة لا بوصفها أداة فضح أو مساءلة، بل كوسيلة تهدئة وتجميل للمأساة، إذ اختُزلت الفتيات في صور وجدانية، غابت عنها أي إشارات واضحة إلى الظروف الطبقية والاقتصادية التي فرضت عليهن الانخراط المبكر في سوق العمل.
فاللغة ليست مجرد وسيلة تعبير، بل كيان ثقافي حي يحمل الذاكرة الجمعية، ويعيد تشكيل الغائب في الوعي العام. فبينما غيّب الثرى أجساد هؤلاء الفتيات العاملات، أبقتهن اللغة على قيد الحياة في الوجدان، محفوظات في مصطلحات خرجت من بيئتهن الاجتماعية، لا من قوالب جامدة أو مقولات جاهزة.
وهنا تبرز المفارقة بين الترجمة الآلية التي تُنتج نصوصًا خالية من الروح، والترجمة البشرية الواعية التي تنبض بالحياة وتُعيد للمعنى سياقه الثقافي والإنساني. فالنص المترجم آليًّا قد ينقل الكلمات، لكنه يعجز عن نقل النَفَس، بينما الترجمة المتخصصة تُشبه الماء، تُحيي النصوص كما تُحيي الأرض اليابسة، وتعيد للمفردات دلالتها الحقيقية المتجذرة في الثقافة.
ليست اللغة في هذا السياق مجرد أداة تواصل، بل ذاكرة مقاومة للغياب؛ فحتى وإن انتهت حياة هؤلاء الفتيات على طريقٍ سريع، فإن كلمات المجتمع التي نشأن فيه، والأغاني والمصطلحات التي وصفتهن، تظل تحفظ حضورهن، وتلك هي قوة اللغة حين تتجاوز الترجمة الجامدة، وتُعيد تشكيل الحياة من عمق الفقد.